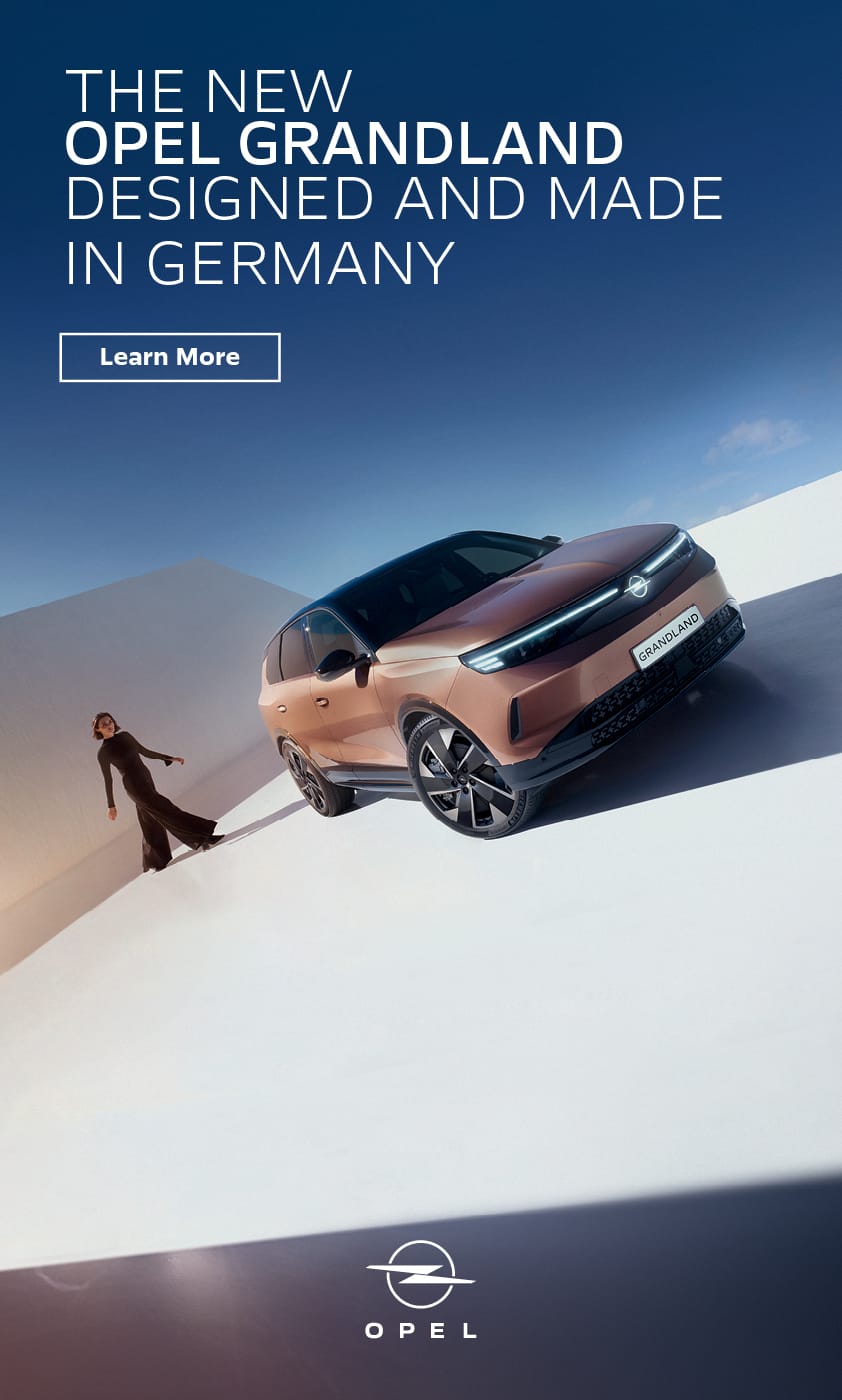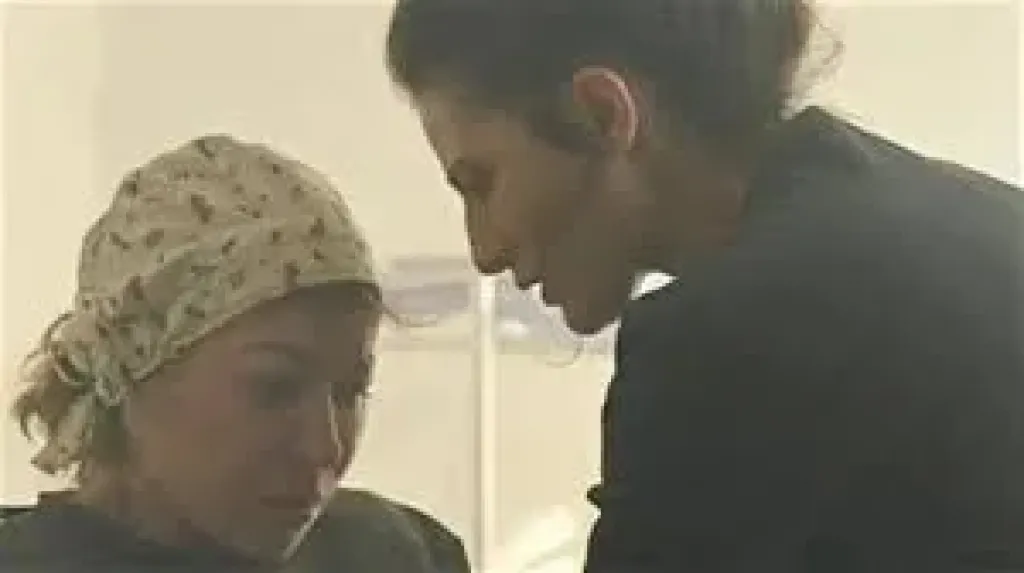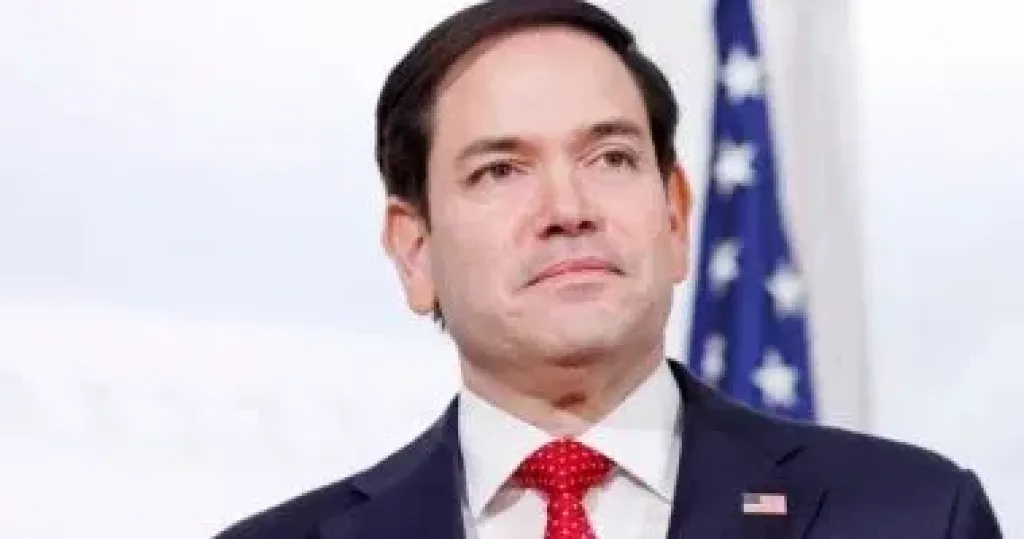شيماء منصور تكتب: في محراب الملك لير.. حين يتجدد سحر الفخراني على خشبة المسرح

في عام 2009، تلقيت دعوة لمشاهدة مسرحية الملك لير للنجم الكبير يحيى الفخراني، والتي كانت تُعرض آنذاك على خشبة مسرح ميامي، من إخراج المخرج القدير أحمد عبد الحليم، كنت وقتها لا أزال أخطو أولى خطواتي في عالم المسرح، وكانت هذه الدعوة بمثابة حلم يطرق أبواب الواقع، ذهبت إلى المسرح وأنا أحمل مزيجًا من الفرحة، والرهبة، والشغف، فرؤية يحيى الفخراني حيًّا على خشبة المسرح، لم تكن لحظة عابرة، بل تحقيقًا لحلم طالما راودني.
أتذكر بوضوح ظهوره الأول على المسرح، كيف خفق قلبي وصفّقت بشغف حتى تورمت يداي، ثم انجرفت تمامًا مع إحساسه، وغُصت في تفاصيل شخصية “لير” وحكاياته مع بناته الثلاث، ورغم أن العرض امتد لأكثر من ثلاث ساعات، تمنيت لو امتد أكثر، فقد كان وجود الفخراني على المسرح كالسحر، لا يُمل ولا يُنسى.
واليوم، في عام 2025، جاءتني الدعوة مجددًا لمشاهدة الملك لير… نفس النص، ونفس النجم الكبير يحيى الفخراني، لكن برؤية جديدة تمامًا، من توقيع مخرج واعٍ، يمتلك حسًا معاصرًا هو المخرج شادي سرور، وفريق عمل ينبض بالحيوية، ذهبتُ هذه المرة وأنا أراهن نفسي، أراهن أنني على موعد مع تجربة مبهرة، لا تُكرر الماضي، بل تُعيد خلقه بروح جديدة، تحفظ عظمته وتضيف إليه.
جلستُ على المقعد في المسرح القومي، كأنني أعود في الزمن، وانتابني الشعور نفسه، نفس الخفقان، ونفس الترقب، ونفس الشغف القديم الذي لم تطفئه السنوات، انتظرت صعود يحيى الفخراني إلى خشبة المسرح، وكأنني لم أشاهده من قبل، رغم مرور أكثر من خمسة عشر عامًا، منذ اللحظات الأولى، شعرت أنني أمام رؤية جديدة تُعيد تقديم النص الكلاسيكي بلغة بصرية وروحية مختلفة، المخرج كان حاضرًا بقوة، ليس منافسًا للنص أو لصوت الفخراني، بل كأنّه يمدّ يده ليقدم الحكاية بشكل مختلف يجعل المشاهد دائما في حالة ترقب دائم لم يسمح المخرج له بالشرود ولو للحظة.
وما كان لروعة هذا العرض أن تكتمل لولا هذا التناغم البديع بين عناصره كافة، فكل تفصيلة على خشبة المسرح وضعت مكانها بدقة متناهية، كل عنصر من عناصر العرض المسرحي بدا وكأنه بطلاً منفرداً يؤدي دوره بإقتدار، جميعها حملت وعيًا جماليًا نادرًا، كأن العرض كله يُكتب من جديد، لكن بلغة لا تُقال، بل تُحس وتُرى وتُعاش.
فإذا بدأنا الحديث عن الممثلين، فلا شك أن السطور تعجز عن احتواء عظمة يحيى الفخراني، وجمال حضوره المسرحي الطاغي، رجل تجاوز الثمانين من عمره، ومع ذلك، ما إن يخطو على خشبة المسرح، حتى تشعر كأنك أمام شاب في الثلاثين، يفيض بالطاقة وخفة الظل والبهجة، الفخراني، النجم الكبير، بذل مجهودًا هائلًا في هذا العرض، لكن حبه الصادق للمسرح، وعشقه العميق لشخصية “لير”، جعله يتجاوز كل تعب، ويُقدّم الدور بروح الهاوي المُحب، لا النجم المُتكلّف، وهذا الشغف الحقيقي لم يكن خافيً، بل وصل بصدق إلى كل فرد من الجمهور، ولامس قلوب الجميع دون استثناء.
كما تألق الفنان الكبير طارق الدسوقي في تجسيد شخصية “جلوستر” النبيل الوفي، وصديق العمر للملك لير، قدّم الدسوقي الدور بحرفية عالية وصدق إنساني لافت، جعلنا نعيش مع الشخصية لحظات إخلاصها وألمها وسقوطها المؤلم، جلوستر ، الذي لم يتخلَّ عن صديقه في محنته، دفع ثمن وفائه غاليًا… عينيه الاثنتين، كما وقع ضحية لخداع ابنه غير الشرعي “إدموند”، الذي دسّ له السم في العسل، ولفّق لأخيه إدجار تهمة باطلة قلبت حياة الأب رأسًا على عقب.
انتهى به المطاف مكسورًا، وحيدًا، لكنه مات وهو بين ذراعي ابنه الشرعي إدجار، بالفعل قدم طارق المشاهد بحرفية كبيرة جعلتنا نبكي.
أما الأخوان “إدموند” و”إدجار”، أبناء جلوستر، فقد جسّدهما ببراعة الفنانان أحمد عثمان وتامر الكاشف. أبدع عثمان في تقديم شخصية “إدموند” الابن غير الشرعي، الذي حمل قلبًا مملوءًا بالغِل والحقد، ونسج المؤامرات لتشويه شقيقه إدجار، والذي قدمه ببراعه أيضا تامر ، ذاك الابن الطيب الوفي
لم يكتفِ “إدموند” بتلويث سمعة أخيه، بل تسبب في تمزيق عائلة كاملة، إذ اضطر “إدجار” إلى الهروب والتخفي لسنوات، متقمصًا شخصية رجل مجذوب، بعيدًا عن وطنه وأبيه، حتى جمعتهما الصدفة مجددًا في لحظة مؤثرة، لم يتعرف فيها الأب على ابنه إلا في نهاية عمره، بعد أن ضاعت الحقيقة، وفي النهاية، انتصر العدل حين قتل “إدجار” شقيقه “إدموند”، بعد سلسلة من الخيانات والمآسي التي زرعها الأخير في طريق الجميع.
وإذا انتقلنا إلى الشقيقات الثلاث: ريجان، وجونريال، وكورديليا، اللاتي جسدتهن ببراعة كل من أمل عبد الله، وإيمان رجائي، ولقاء علي، نجد أن اختيار المخرج لهن كان موفقًا إلى حد بعيد. فقد تماهت كل ممثلة مع شخصيتها حتى شعرت وكأن الدور قد كُتب خصيصًا لها، استطعنا أن نلمس الحقد والأنانية في أداء ريجان وجونريال، اللتين لم تحركهما مشاعر الأبوة بقدر ما حرّكتهما مصالحهن الخاصة. في المقابل، جاءت كورديليا - التي لا تعبّر عن مشاعرها بالكلمات بقدر ما تُجسدها بالأفعال - رمزًا للوفاء والحنان، ورغم أنها كانت الضحية الأولى في قرارات لير عندما طردها وحرَمها من الميراث لأنها لم تنافقه كما فعلت أختاها، إلا أنها كانت اليد الوحيدة التي امتدت إليه حين تخلى عنه الجميع، وعندما ماتت في النهاية لم يستطع تحمل ذلك وكان بين ذراعيها على الفور وكأن روحه أبت أن تعيش لحظة بعد فقدانها.
ولم يكن ممكنًا أن نغفل الأداء اللافت للمهرج “بهلول”، الذي جسده الفنان المبدع عادل خلف بخفة ظل ساحرة جعلته بمثابة “بونبوناية العرض” بحق، فقد أضفى حضورًا مميزًا ومحببًا وسط تعقيدات النص التراجيدي.
كما برع الفنان محمد العزايزي في تجسيد شخصية دوق كورنوال، ذلك الرجل القاسي الذي كرهه الجمهور منذ لحظة ظهوره، وقد لعب العزايزي على مناطق دقيقة في التعبير الصوتي والانفعالي، فأوصل لنا شرّ الشخصية بكل صدق وإتقان، أما الفنان القدير حسن يوسف، فقدم دور الرجل الوفي ببساطة وصدق، ذاك الرجل الذي ظل مخلصًا للملك منذ البداية، وكان أول من نصحه بعدم ظلم ابنته الصغرى، مؤمنًا بأن الحب الصادق لا يُقاس بالكلمات المنمقة، بل بالفعل الصادق، ولا يمكننا كذلك أن نغفل الأداء المتميز للفنان محمد حسن، الذي أضاء خشبة المسرح بحضوره المتوهج وتعبيره الصادق. إلى جانب العديد من الممثلين الذين قدّم كلٌّ منهم أداءً بارعًا، ساهم في اكتمال هذه اللوحة المسرحية المدهشة.
وكما ذكرنا سلفاً أن عناصر العرض كانت متناغمة أعطتنا صورة متكاملة للعرض، فإذا نظرنا للديكور والذي صممه الدكتور حمدي عطية جاءشديد الذكاء في توظيفه، فقد اعتمد على شاشات العرض لكنك في لحظة تشعر وكأنها جزءاً حياً، وعلي سبيل المثال من المشاهد لا الحصر، مشهد العاصفة، كان ماأروعه حيث جاء الديكور هو البطل الأساسي له،فالديكور نجح في خلق حالة بصرية تلائم أجواء النص التراجيدي وتُبرز الصراع الداخلي للشخصيات، أما الملابس التي صممتها علا علي جاءت معبرة بدقة عن طبيعة كل شخصية، واختياراتها كانت مدروسة لتعكس الفوارق الطبقية والنفسية، مما أضاف لعمق الأداء وصدق الحالة الدرامية، وقدم الفنان ضياء شفيق استعراضات العرض بحرفية مشهودة له حيث استطاع توظيفها في موضعه تمامًا، وخدمت الحالة الشعورية للمشهد دون أن تشتت، وكانت حركتها متناغمة مع السياق العام للعرض، أما الإضاءة الذي صممها الفنان محمود الحسيني لعبت دورًا محوريًا في إبراز المشاعر والتحولات الدرامية، فجاءت مزيجًا بين الجمال البصري والدقة التقنية، لتدعم السرد المسرحي بذكاء وحس فني عالي.
وختاماً فإن المخرج شادي سرور كان في مواجهة تحدٍ استثنائي؛ فهو لا يتعامل فقط مع نص شكسبيري عظيم قُدم مئات المرات حول العالم، بل يتعامل أيضًا مع نسخة محفورة في وجدان الجمهور العربي قدمها النجم الكبير يحيى الفخراني أكثر من مرة، التحدي كان مضاعفًا، فكيف يصنع الاختلاف دون أن يتنكر لجلال النص؟ وكيف يُعيد تقديم لير الفخراني بشكل لا يبدو مكررًا أو تقليديًا؟ وقد نجح المخرج بالفعل في كسب هذا الرهان الصعب، عبر رؤية واعية، وحس إخراجي مرهف، جعل كل تفصيلة في العرض ناطقة بالحياة، فبدا العمل وكأنه يُولد من جديد، بروح طازجة، وإيقاع عصري، دون أن يفقد عمقه الكلاسيكي أو هيبته الأدبية.